
كان ولا يزال البحث عن "مبادئ حاكمة" موضع اهتمام كبير في التراث الإسلامي، حيث إن كلمة "مبادئ" أو ما يقابلها من مفردات مثل "أصول" و”أسس" أضحت جزءا من الإسم الذي يطلق على بعض العلوم والمعارف مثل علم أصول الفقه. إلا أن الحقل المعرفي الناشئ "الإسلام والأخلاق الطبية والحيوية" لا يزال مفتقرا إلى جهود علمية تعكف على صياغة منظومة منضبطة ومتماسكة للمبادئ الحاكمة لمجال الأخلاق الطبية والحيوية. ومن جهة أخرى، انشغل الباحثون المعنيون بمجال الأخلاق الطبية والحيوية في الأكاديميات الغربية منذ عقود بصياغة نظرية للمبادئ الحاكمة في هذا المجال. ويعدّ الفيلسوفان الأمريكيان تومب بوشامب وجيمس تشايلدرس أبرز من أسهم في هذا الصدد عندما قاما بتأليف كتاب "مبادئ الأخلاق الطبية والحيوية" والذي صدر في طبعته السابعة عام 2013. هذا وقد أثار الكتاب عددا كبيرا من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة للنظرية التي طرحها الكاتبان ومدى عالمية المبادئ الأربعة التي اقترحاها وهي: (1) احترام الاستقلالية الذاتية والحرية، (2) عدم الضرر، (3) تحقيق المنفعة والمصلحة، (4) العدل. ولمناقشة هذا الموضوع من زواياه المختلفة عقد مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق ندوة دولية تحت عنوان "مبادئ الأخلاق الطبية والحيوية من منظور إسلامي" جمعت بين عدد من المتخصصين في مختلف المجالات خلال الفترة 5-7 يناير 2013.
عقد مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق ندوة دولية خلال الفترة من 5 -7 يناير 2013 حول مبادئ أخلاقيات الطب الحيوي من منظور إسلامي، بالعاصمة القطرية الدوحة. وشارك في هذه الندوة أربعة من الفقهاء المسلمين وطبيبان مسلمان واثنان من المتخصصين في مجال أخلاقيات الطب الحيوي. وكان من بين الفقهاء المشاركين: الشيخ الدكتور أحمد الريسوني (المغرب)، والشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة (سوريا)، والشيخ الدكتور علي القره داغي (قطر)، والشيخ عبد الله بن بيّه (موريتانيا). وشارك في الندوة الطبيبان: الدكتور حسن شمسي باشا (سوريا) والدكتور محمد علي البار (المملكة العربية السعودية). كذلك شارك اثنان من فلاسفة أخلاقيات الطب الحيوي هما توم بوشامب [Tom Beauchamp] من الولايات المتحدة الأمريكية وأنيلين بريدينورد [Annelien Bredenoord] من هولندا. وقدَّم الفقهاء المشاركون أوراقاً بحثية عدا الشيخ عبد الله بن بيّه. كما قدم بوشامب وبريدينورد ومحمد البار أوراقاً بحثية كذلك، لكن ورقة بريدينورد جاءت بعد انتهاء الندوة. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في هذه الأوراق البحثية تحت عنوانين رئيسيين: (أ) مبادئ أخلاقيات الطب الحيوي: ونعرض تحت هذا العنوان أهم ما جاء في بحوث كل من بوشامب وبريدينورد والبار (ب) الرؤية الإسلامية: ويتناول خلاصة ما كتبه الريسوني وأبو غدة والقره داغي.
- مبادئ أخلاقيات الطب الحيوي
يتناول توم بوشامب في بحثه بعنوان "مبادئ أخلاقيات الطب الحيوي باعتبارها مبادئ عامة" دور هذه المبادئ في ما يُسمى "مقاربة المبادئ الأربعة" في حقل أخلاقيات الطب الحيوي. وتنقسم ورقته البحثية إلى خمسة مباحث. المبحث الأول يتناول طبيعة هذه المبادئ ومصادرها في حقل الأخلاقيات الطبية الحيوية الذي تشكلت معالمه خلال فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات خاصة من خلال كتابه الذي اشترك في تأليفه مع جيمس تشايلدرس [James Childress]. ويرى بوشامب أن أي مبدأ أساسي في نظرية المبادئ هذه هو معيار أخلاقي مجرد. وهذا التجرد يعني أن الأحكام العملية لا يمكن استخلاصها بشكل مباشر من هذه المبادئ الأساسية. ومع ذلك يمكن صياغة قواعد أكثر تحديدا في مجال أخلاقيات الطب الحيوي بالرجوع إلى تلك المبادئ. كما يرى بوشامب أن هذه المبادئ مقيدة بالسياقات التي ترد فيها وليست مطلقة ولا غير مشروطة، وبالتالي لا يوجد لها ترتيب ثابت ومطرد. ويركز هذا المبحث على شرح المبادئ الأربعة التي يطرحها بوشامب وتشايلدرس وهي: (1) احترام الاستقلالية والحرية الذاتية (وهو مبدأ لا ينبغي الخلط بينه وبين مذهب الفردانية [individualism] لأن هذا المبدأ يعني ضرورة احترام أهلية الأشخاص المستقلين بذاتهم فيما يتعلق بقدرتهم على اتخاذ القرار)، (2) عدم الأذى والضرر (وهو مبدأ يتطلب تجنب إلحاق الأذى بالآخرين)، (3) الإحسان وفعل الخير (وهو مجموعة من المبادئ تستلزم الحد من الضرر ومنعه علاوة على تقديم المنفعة للآخرين)، (4) العدالة (وهي مجموعة من المبادئ تستلزم التوزيع العادل للمنافع والمخاطر والتكاليف على جميع الأطراف المعنية).
يتناول المبحث الثاني من بحث بوشامب الدور المحوري لمقاربة المبادئ الأربعة من خلال نظرية الأخلاق المشتركة والتي يشرحها قائلا بأنها تتألف من مجموعة متكاملة من القواعد الأخلاقية العامة التي تمثل قاسما مشتركا بين كل من يلتزم الأخلاق منهجاً في حياته. ويرى بوشامب أن المرء في حاجة للتمييز بين أنواع أربعة من المفاهيم حتى يستوعب نظرية الأخلاق المشتركة؛ وهي المبادئ (والقواعد)، والفضائل، والمُثل، وأخيرا الحقوق. فعلى سبيل المثال تشتمل المبادئ العامة وقواعد الالتزام في نظرية الأخلاق المشتركة على مجموعة من القواعد المحددة من بينها: لا تقتل؛ لا تسبب المعاناة والألم للآخرين؛ اعمل على منع وقوع الشر أو الأذى؛ اعمل على إغاثة الأشخاص الذين يتعرضون للخطر. أما الفضائل العامة، فقد مثّل لها بوشامب بالأمانة والنزاهة والاستقامة والإخلاص. كما أن المُثل الحميدة هي جزء لا يتجزأ من نظرية الأخلاق المشتركة كالعفو والكرم الفائق والرحمة البالغة. أما فيما يتعلق بالحقوق فيرى بوشامب أنها مطالب أخلاقية مشروعة بوجه عام، وقد ترسخ هذا الفهم للحقوق على الأقل منذ بدايات النظريات الحقوقية الحديثة التي نشأت وتطورت في القرن السابع عشر.
يتناول بوشامب في المبحث الثالث أحد الأسئلة الملحة التي يثيرها منتقدي مقاربة المبادئ الأربعة، وهل هذه مبادئ عامة بالفعل أم أن صبغتها بتقى في النهاية صبغة غربية أو أمريكية فقط؟ وفي معرض رده على هذا السؤال أشار بوشامب إلى ضرورة التمييز أولا بين نظرية الأخلاق المشتركة وما تشمله من معايير وقواعد تتسم بالعموم والبساطة والتجريد من جانب و من جانب آخر الأخلاقيات الخاصة ذات القواعد التي تتسم بالخصوصية وعدم العموم والثراء في التفاصيل بالإضافة إلى واقعيتها. يرى بوشامب كذلك أنه ينبغي التمييز بين الأخلاق بمعناها الوصفي والأخلاق بمعناها المعياري حيث أن الأخلاق بمعناها الوصفي تشير إلى مجموعة من اللوائح وقواعد السلوك التي تلتزم بها مجموعة ما وبالتالي يمكن أن تنتج تنوعا في الأخلاقيات والتي يمكن تبريرها جميعا. إلا أن هذا المعنى الوصفي للأخلاق لا يكون بالضرورة ملزما فيما يتعلق بالأخلاق بمفهومها المعياري لأنها معنية بالطريقة المثلى التي ينبغي لجميع الأشخاص اتباعها في سلوكياتهم وتصرفاتهم. ويخلص بوشامب إلى نتيجة مفادها أن القاسم المشترك بين جميع الأخلاقيات الخاصة التي يمكن تبريرها هو اتساقها وتناغمها مع تتشارك مع المعايير الموجودة في نظرية الأخلاق المشتركة.
يخصص بوشامب المبحث الرابع للحديث عن أحد المصطلحات المفتاحية المتعلقة بمقاربة المبادئ الأربعة ألا وهو التعيين أو التخصيص [specification] ويقصد بالتخصيص، في السياق الأخلاقي، إضافة وتخصيص إرشادات معينة لتلك المبادئ العامة تهدف إلى ضبط الأفعال والممارسات. وهذا لأن المبادئ -كما أسلفنا- تتسم بالعموم والبساطة في المحتوى وبالتالي لا بد من تخصيصها حتى تأخذ طابعا عمليا. ويقر بوشامب بحقيقة أن الناس دائما ما يصطدمون بأكثر من طريقة للتخصيص تتعارض مع بعضها البعض وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا خلافية مثل الإجهاض وإجراء التجارب والبحوث على الحيوانات، والقتل الرحيم حتى وإن قام بعملية التخصيص هذه أطراف تتحلى بأكبر قدر من المنطق والحيادية والالتزام بالأخلاق المشتركة. ويخلص بوشامب إلى القول بأن التخصيص في نهاية المطاف يبقى مبرراً إذا اتسق مع معايير الأخلاق المشتركة وعزز من ترابط وتماسك المنظومة المتكاملة للمعتقدات التي يمكن تبريرها ويؤمن بها الطرف الذي يقوم بعملية التخصيص.
في المبحث الخامس والأخير يبرهن بوشامب على الصلة القائمة بين مقاربة المبادئ الأربعة والنقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعددية الثقافية والإمبريالية الثقافية. ويرى أن هذه الثنائية المزعومة والفصل ما بين الشرق والغرب فيما يخص التقاليد الأخلاقية المتعلقة بالحرية والحقوق واحترام الاستقلالية والحرية الذاتية، واحترام الأسرة لا أساس لها. إلا أن بوشامب يقر بوجود بعض الفروق المعقولة التي لها ما يبررها بين البلدان بعضها البعض. فعلى سبيل المثال لا يمكن القول بأن مبدأً مثل احترام استقلالية الفرد يحظى بنفس المنزلة والأهمية في الثقافة الشرقية تماماً كما هو الحال في بعض الثقافات الغربية.
وتحت عنوان "إعادة النظر في مبادئ أخلاقيات الطب الحيوي" تسعى أنيلين بريدينورد في بحثها إلى إعادة تقييم لمقاربة المبادئ الأربعة وذلك من خلال مبحثين أساسيين. في المبحث الأول تقدم إطلالة عامة على المبادئ الأربعة لأخلاقيات الطب الحيوي وفق ما قرره بوشامب وتشايلدرس، وتتناول الإشكاليات الأساسية التي أثيرت حول كل مبدأ من هذه المبادئ، ثم تبين وجهة نظرها وردها على هذه الاعتراضات. وفيما يتعلق بمبدأ احترام الاستقلالية والحرية الذاتية، تناقش الباحثة ثلاثة اعتراضات رئيسية، أولها أن هذا المبدأ مغرق في الفردانية لأنه في النهاية لا يمكن للاستقلالية أن تتواجد بمعزل عن العلاقات. والانتقاد الثاني يتعلق بمدى الاستقلالية ونطاقها لأن بعض الناس يحرمون من التمتع باستقلالية تامة إما بشكل مؤقت أو دائم مثل القُصّر والمرضى العقليون ومن هم في غيبوبة أو فاقدو الوعي. وهناك انتقاد ثالث لمبدأ احترام الاستقلالية يرى أن التركيز الشديد على هذا المبدأ بحيث يحتل مساحة مركزية مبالغ فيها لا يترك مجالاً للمصالح المجتمعية التي يمكن أن تزاحم هذا المبدأ. وترى بريدينورد أنه قد تكون هناك بعض الاعتراضات الأخرى الناتجة بشكل جزئي عن تفسير خاطئ أو أحادي البعد لمفهوم الاستقلالية والحرية الذاتية. وبخلاف الاستقلالية، يبدو أن مبدأ عدم الضرر أقل المبادئ إثارة للجدل والخلاف. والاعتراض الذي قد يرد عليه هو صعوبة التفريق بينه وبين مبدأ الإحسان في أحيان كثيرة. وفيما يخص مبدأ الإحسان، فإن أحد الاعتراضات الرئيسية التي تناولتها الباحثة انصبّ على تحديد نطاق هذا المبدأ وتمييز حدوده ومعالمه. فعلى سبيل المثال قد يؤدي الاستخدام غير المشروط لهذا المبدأ من جانب الأطباء إلى تقمص شخصية الأب في معاملتهم للمرضى على أنهم أبناء يجب أن يستمعوا دوما لنصائح الأب الذي يرعاهم ويحسن إليهم وهو ما يسمى في أدبيات أخلاق الطب الحيوي بالأبوية غير المبررة (unjustified paternalism). وبالنسبة لمبدأ العدالة، ترى الباحثة أنه على الرغم من أهميته إلا أنه يبقى "فارغاً" إذا تم أخذه بمفرده، ولذا يحتاج دوماً إلى نظرية للعدالة لملء هذا الفراغ. والعمل الأخلاقي الحقيقي يتجسد في اختيار نظرية للعدالة وتبريرها ثم بيان ما يمثل عنصراً للاختيار والتمييز يكون مبرراً من الناحية الأخلاقية.
ويركز المبحث الثاني من ورقة بريدينورد على تحديد ثلاث نقاط رئيسية تثير جدلاً مستمرا حول مدرسة المبادئ كنظرية ومنهج في الأخلاق الحيوية. تتمثل النقطة الأولى مثار الجدل في تحديد المنهج الملائم، هل هو الانتقائي أم التعددي، وهل هذه المبادئ العامة من الدقة والوضوح بمنزلة تجعلها تصلح لتشكيل نظرية في أخلاقيات الطب الحيوي؟ جدير بالذكر أن منهج المبادئ الأربعة قد حاز على الاستحسان باعتباره أداة تعليمية متاحة وإطار عمل عملي لتحليل قضايا الأخلاق الحيوية اليومية. لكنه لم يسلَم من النقد لافتقاده نظرية أخلاقية واحدة تربط المبادئ الأربعة ببعضها البعض، ولذا لا ينتج عنه دليل إرشادي عملي يعطينا قواعد واضحة متماسكة للعمل ولا تبريراً لتلك القواعد. وترى بريدينورد أن هذا الجدل جزء من جدل معرفي أكبر في مجال الأخلاقيات حول كُنه النظرية الأخلاقية أو الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أنصار النزعة التأسيسية أن تكون النظرية الأخلاقية مكتملة واضحة تقدم توجيهات جلية بشأن الإجراءات الصحيحة من الناحية الأخلاقية، نجد أنصار مدرسة المبادئ، بما فيهم بوشامب وتشايلدرس، متساهلين فيما يخص النظرية الأخلاقية وأكثر ميلاً لقبول إطار مرن في التشاور والتداول المعياري. أما عن النقطة الثانية مثار الجدل، فتتمثل في وجود تراتب وتسلسل محتمل بين المبادئ الأربعة وكيفية ارتباطها ببعضها البعض. ويرى بوشامب وتشايلدرس أنه لا يوجد مبدأ بين هذه المبادئ الأربعة يطغى على ما سواه من الاعتبارات الأخلاقية. ومع ذلك ترى بريدينورد أن ثمة أسباب معقولة تدعونا لإضفاء أهمية خاصة على مبدأ احترام الاستقلالية أو الحرية الذاتية. وتتمثل النقطة الأخيرة المثيرة للجدل فيما يخص منهج المبادئ الأربعة في مسألة التخصيص أو كيف نصل من خلال هذه المبادئ الأخلاقية العامة إلى أحكام أخلاقية ملموسة. وبخلاف المبادئ العامة التي يمكن لجميع البشر اعتناقها والإيمان بها، تختلف الأحكام الأخلاقية المخصصة من شخص لآخر، ولكن هذا الأمر يستلزم عناية وتهذيباً من آن لآخر كلما استجدّت لدينا معلومات تستدعي ذلك.
وإذا انتقلنا إلى بحث الدكتور البار بعنوان "المبادئ الأربعة لأخلاقيات الطب الحيوي" نجده لم يقتصر على مناقشة المبادئ الأربعة التي صاغها بوشامب وتشايلدرس وإنما تخطاها إلى ما هو أكثر من ذلك. فقسَّم بحثه إلى ستة مباحث رئيسية. استعرض في المبحث الأول رؤى الفلاسفة اليونانيين والمسلمين علاوة على أفكار عدد من الفلاسفة والمفكرين المعاصريين حول طبيعة الأخلاق وهل هي فطرية أم مكتسبة بالدربة والتعلم. وأفاض الباحث في الحديث عن أهمية وجود دوافع أخلاقية لإضفاء الصبغة الأخلاقية على فعل ما والحكم عليه بأنه فضيلة، وقد استشهد بأحاديث نبوية لهذا الغرض، كما اقتبس من بوشامب وتشايلدرس ما يدعم وجهة نظره. واقتبس من أقوال الفلاسفة المسلمين وغيرهم، ومن الأقوال النبوية ما يؤيد رأيه في أن الفضائل الأساسية في مجال الطب والرعاية الصحية هي الرحمة والأمانة والإخلاص والفطنة وحسن التمييز والضمير الحي. واستعرض البار في المبحث الثاني بشيء من التفصيل القواعد الأخلاقية في المهنة الطبية عبر التاريخ. وأولى في هذا المقام عناية خاصة لقَسَم أبقراط ومنزلته الكبيرة في تاريخ الأخلاقيات الطبية. كما تناول بالتفصيل موقف الدين الإسلامي من العلاج الطبي والعلاقة بين الطبيب والمريض. وخصص جزءاً كبيراً من هذا المبحث للقواعد الطبية التي صيغت في العصر الحديث مثل مبادئ نورمبرج (لعامي 1947، 1946) وإعلان هلسنكي (1964). واستشهد في هذا السياق بالفتوى الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي في مكة في ديسمبر 2003 بشأن العلاج بالخلايا الجذرية. وتحت عنوان "بحوث الطب الحيوي بلا ضابط رغم القواعد والمبادئ الأخلاقية" اختتم البار هذا المبحث بقائمة مطولة من الحالات التي وقعت في الفترة من 1915 حتى 2012 وشهدت انتهاكاً صارخاً لأساسيات أخلاق البحوث الحيوية. وخصص مبحثاً مستقلاً لكل مبدأ من المبادئ الأربعة: الاستقلالية أو الحرية الذاتية، وعدم الضرر، والإحسان، والعدالة. وقد انتهج في تناوله للمبادئ الأربعة منهجاً متسقاً؛ مقتبساً من كتاب Principles of Biomedical Ethics (مبادئ أخلاقيات الطب الحيوي) الذي ألفه بوشامب وتشايلدرس، مورداً العديد من الشواهد من القرآن والسنة وآراء الفقهاء القدامى والمعاصرين.
- المنظور الإسلامي
قدم الدكتور الريسوني ورقة بحثية بعنوان "الأخلاق في الطب: تأسيس مقاصدي". وتتمثل الفرضية الأساسية لهذا البحث في أن الأخلاق كلٌّ لا يتجزأ ولا يمكن تقسيمها إلى أجزاء متعددة كل منها يختص بمنحى معين من مناحي الحياة: الطبية أو السياسية أو الاقتصادية أو العلاقات الاجتماعية. ومع ذلك يرى الريسوني أن ثمة مبادئ معينة ومجموعة محددة من القيم يمكن إبرازها بشكل أكبر في مجالات خاصة لأنها تؤتي ثمارها في هذا المجال أكثر من غيرها من القيم والمبادئ. وبعد هذه المقدمة، يقسّم الريسوني بحثه إلى مبحثين أساسيين. يتناول في المبحث الأول منزلة الأخلاق في الشريعة ومقاصدها. ويرى في هذا الصدد أن الحياة بكل ما فيها ينبغي أن تُؤسس على الأخلاق. ثم يركز في المبحث الثاني على الأخلاق في المجال الطبي. ويرى في هذا المبحث أن كل مجالات الحياة في حاجة ماسة إلى الأخلاق حتى يكون لها معنى ومغزى، وأن المجال الطبي على وجه الخصوص لا يمكن له أن يستمر إلا إذا تأسس على الأخلاق. ويوضح الريسوني التلاحم بين مقاصد الشريعة ومقاصد الطب، حيث تتمثل المقاصد العليا للشريعة في حفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والنسل والعقل والمال. ومقاصد الطب لا تخرج عن حفظ النفس والنسل والعقل. فهي تشترك مع مقاصد الشرع في ثلاثة من خمسة.
ويرى الريسوني أن من الأخلاق التي لا يستقيم بدونها شرع ولا طب: خُلُق التقوى والرحمة. ويوضح أن التقوى في استعمالات الشرع تعبِّر عن حالة خُلُقية، قلبية نفسية، تجعل صاحبها مرهف الشعور بالمسؤولية ومحاسبة النفس، مقدِّراً لعواقب الأفعال وآثارها، فيتصرف بناء على ذلك من تلقاء نفسه، سواء تعلق ذلك بنفسه، أو بربه، أو بأي كان من خَلْق الله. والتقوى تنبعث من رقابة ذاتية يمارسها كل واحد على نفسه ومن داخل نفسه. ولذلك فهي حاضرة مع صاحبها في كل وقت وحين. فالإنسان في حياته يمكن أن يغيب عن الناس ويغيب عنه الناس، فيتخلص من رقابتهم ومحاسبتهم ولومهم وضغطهم، ولكن تقواه تظل حاضرة معه رقيبة عليه موجهة لسلوكه، في سره كما في علنه. ولذا فإن التقوى هي للطبيب مصدر الاستقامة الداخلية. فنزاهةُ الطبيب التقي وأمانته لا تتوقف على القَسَم الطبي. وأما من حُرم فضيلة التقوى وفقدَ محاسبةَ نفسه بنفسه، فلا ينفع معه قسم يوناني ولا إسلامي. وفيما يخص الرحمة يرى الريسوني أنها خلق لازم لا يستقيم بدونها شرع ولا طب. وفي ختام البحث يتناول الريسوني مسألة القتل الرحيم التي تتم بداعي الرحمة والشفقة وإنهاء المعاناة، وهو أمر لا أساس له من الصحة لسببين: ليس هناك ألم يمكن أن يكون وزنه أرجحَ من حفظ الروح البشرية التي هي من أسمى المقاصد الشرعية. كما أن الرحمة في العقيدة الإسلامية ليست مفهوماً دنيوياً خالصاً، وإنما تشمل كذلك رحمة الآخرة وما يفضي إليها من توبة وصبر ومغفرة وثواب. وقد صح في الأحاديث النبوية أن الآلام فيها محو السيئات ورفع الدرجات، تخفيفا من ربكم ورحمة.
وتحت عنوان "المبادئ الحاكمة للأخلاق الإسلامية في الطب" قدم الدكتور أبو غدة بحثه. ويتكون البحث من ثلاثة مباحث رئيسية مذيلاً بالوثائق الصادرة عن الجمعية الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية. ففي المبحث الأول يشرح الباحث مدى عناية الشريعة الإسلامية بالأخلاق عامة. ويرى الباحث أن الأنظمة القانونية الوضعية معنية بالحقوق والواجبات من منظور قضائي بحت. إلا أن الشريعة الإسلامية تجمع بين الحقوق والواجبات في إطار أكبر تحتل فيه الأخلاق والسلوكيات الأخلاقية منزلة سامية. ولذا فإن الأدبيات الإسلامية التي تُعنى بتوضيح الحلال والحرام في الإسلام، زاخرة بالقضايا المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. حتى إن بعض الفقهاء قد خصَّص باباً مستقلاً لهذه القضايا الأخلاقية، ومنهم من أفرد لها كتاباً تحت اسم الجامع. والقيم الأخلاقية وكذلك العقيدة والشريعة والقيم الفكرية هي لتحقيق أهداف عليا قد يقترن بها الهدف المادي العاجل. وقد يتراخى عنها، فيدَّخر إلى يوم القيامة. ولذا تجب مراعاة القيم الخلقية ولو ألحقت ضرراً بالإنسان، لأن في مقابلة ذلك الضرر النفع الحقيقي الذي هو رضا الله تعالى.
ويعالج المبحث الثاني قضية المصطلحات، ويشرح فيه أبو غدة مجموعة من المصطلحات الأساسية مثل: الأخلاقيات والقيم والسلوكيات. ويقسم الباحث علم الأخلاق إلى علم الأخلاق الفلسفي، وعلم الأخلاق الديني. والأول يعتمد على العقل والطرق الفلسفية البحتة في تحليل الوقائع الخلقية. بينما يعتمد الثاني على الوحي، ويستمد من الدين مبادئ الأخلاق. على أن إضفاء هذا الطابع العقدي على علم الأخلاق الديني لا يلغي دور العقل والفكر الإنساني، فهذا من قبيل الوسائل التي تأخذ حكم المقاصد. ويشير أبو غدة في هذا المبحث إلى المبادئ الأربعة لأخلاقيات الطب الحيوي التي صاغها بوشامب وتشايلدرس لكن دون ذكر لهما. فهو يقتبس هذه المبادئ من مصدر عربي يرى أن هذه المبادئ أضحت مشتركة بين معظم دول العالم. وعلاوة على المبادئ الأربعة (الاستقلالية، والإحسان، وعدم الضرر، والعدالة) يشير أبو غدة إلى مجموعة من أخلاقيات الطبيب الإسلامية التي أوردها أحد العلماء المسلمين الأوائل ومنها: بذل النصح، والرفق بالمريض، وإذا رأى علامات الموت لم يكره أن ينبِّه على الوصية بلطيف من القول.
وفي المبحث الثالث والأخير يذكر الباحث مجموعة من الأخلاق الإسلامية الأساسية في مجال الطب. وهذه الأخلاقيات تستند إلى النصوص الشرعية من القرآن والسنة ومن كتابات علماء المسلمين الأوائل وبخاصة ما كتبه أبوبكر الرازي في كتابه "أخلاق الطبيب". وتضم القائمة العناصر التسعة الآتية:
- الحصول على الخبرة الطبية.
- موافقة ممارسات الطبيب للأصول الفنية المعتادة.
- المعرفة الشرعية بالأحكام المتعلقة بالتطبيب.
- التقوى ومراقبة الله تعالى.
- الإخلاص في العمل.
- التواضع لله تعالى، والرفق بالمرضى.
- الصدق والأمانة.
- احترام التخصصات الطبية.
- كتمان السر.
وقدَّم الدكتور القره داغي بحثاً بعنوان "صياغة المبادئ الأخلاقية في ضوء مقاصد الشريعة وضوابطها". وينقسم هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث رئيسية. يبين الباحث في التمهيد أن الأخلاق في الإسلام غاية عامة وليست وسيلة، فهي بمجموعها ليست شعبة من الإسلام وإنما هي إحدى الغايات الأساسية له التي تسري في جميع مفاصل الحياة. وهذه حقيقة تشهد لها عدة نصوص إسلامية سواء تلك التي تتناول قضايا ترتبط بالعقيدة والإيمان أو التي تعالج مشكلات عملية في المجتمع. وكل هذه النصوص تؤكد على أهمية رعاية الأخلاق ونشر السلوك الأخلاقي في المجتمع حتى يحظى الناس بحياة طيبة. ويرى الشيخ القره داغي أن القيم والأخلاق والفضائل في الإسلام تنقسم إلى ثلاث فئات أساسية. منها ما جعله الإسلام من الفرائض والواجبات وأوجب على فعل مخالفتها العقوبات من الحدود والقصاص والتعزيرات. ومنها ما فرضها الله تعالى، ولكن لم يضع لها عقوبات في الدنيا. ومنها ما جعلها من الفضائل والمثل العليا مثل: الإيثار.
وفي المبحث الأول يوضح القره داغي كيفية الاستفادة من المقاصد العليا للشريعة، كما بينتها العديد من الكتب على مدار التاريخ الإسلامي، في صياغة رؤية إسلامية للأخلاقيات الطبية الحيوية. وإلى جانب المقاصد الستة المعروفة (حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ العرض) يضيف القره داغي مقصدين آخرين هما: حفظ أمن الدولة الشرعية، وأمن الجماعة والمجتمع. ويرى أن كل مقصد من هذه المقاصد الثمانية يمكن أن يشكّل في إطار الطب والرعاية الصحية أساساً صلباً لمجموعة من الأخلاقيات الطبية. فمقصد حفظ الدين يمكن الاستفادة منه في حفظ دين المريض ومعتقداته. لذلك على الطبيب أن لا يستعمل تجربة أو علاجاً يتعارض مع عقيدة المريض إلاّ في حالة الضرورة، وإلا كان هذا الأمر منافياً للأخلاق. ومقصد حفظ النفس لا يقتصر على حماية بدن المريض من الأضرار، وإنما يشمل الحفاظ على الصحة العقلية والنفسية كذلك. وحفظ الحياة ليس حق المريض فقط، وإنما واجب وفق الرؤية الإسلامية. ولذا كان القيام بقتل المريض لإراحته من مرض عضال ميؤوس منه أمراً محظوراً في نظر الإسلام حتى لو أذن المريض. ومقصد حفظ العقل معناه في هذا السياق التزام الطبيب بتجنب أيّ علاج يضرّ بالعقل، فاستعماله عمل غير أخلاقي. ومما يتعلق بالعقل هو حريته واستقلاله، فلا يجوز أن يمنع عن حريته في اتخاذ القرار في العلاج والتجارب. وإذا طبقنا مقصد حفظ المال في مجال الرعاية الطبية، يظهر ذلك من خلال واجب الطبيب أو المؤسسة الطبية في الحصول على الرسوم والأجور المعقولة. بل لا يُسمح للمريض نفسه بالتبذير والإسراف وإنفاق المال على علاج غير لازم. وفيما يتعلق بمقصد حفظ النسل، يكون الإجهاض – ما عدا بعض حالات خاصة بالبقاء على حياة الأم – عملاً غير أخلاقي. أما مقصد حفظ العرض، فيقتضي من الطبيب أن لا يتصرف أيّ تصرف أو أن ينشر أسرار المريض إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بعرضه وكرامته وشخصيته. ويبقى المقصدان الأخيران المتعلقان بالحفاظ على الدولة الشرعية والمجتمع، ويتصلان بمسألة العدالة وتوزيع الموارد. ويرى الشيخ القره داغي أن هذا المنهج المقاصدي لصياغة مبادئ الأخلاق الطبية الحيوية يستوعب المبادئ الأربعة المقترحة من جانب بوشامب وتشايلدرس، وذلك أن رعاية أيّ مقصد من المقاصد الثمانية تقتضي أمرين: درء الضرر والمفسدة، وتحقيق المصلحة والمنفعة، وهذان مبدآن من المبادئ الأربعة، كما أن مبدأ احترام الاستقلالية يدخل في الحفاظ على مقصد الدين ومقصد النفس، ومبدأ العدل يدخل في مقصد المجتمع والجماعة، كما أنه يدخل في مقصد الدين أيضاً.
وقد خصص القره داغي المبحث الثاني لمجموعة من القواعد الفقهية الحاكمة والضابطة للمنهج المقاصدي في المبادئ الأخلاقية الطبية. وفي هذا الصدد يورد البحث قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، واليقين لا يزول بالشك. كما يشير الباحث إلى فقه الموازنات لدرء التعارض بين المصالح والمفاسد في بعض الحالات. وفيما يتعلق بقضية اليقين والشك يرى القره داغي أن القرار في المجال الطبي لا يمكن أن يعتمد في جميع الأحوال على اليقين. ولذا أقر الإسلام مبدأ الظن الغالب في اتخاذ القرار الطبي المناسب.
وفي المبحث الثالث يورد القره داغي مجموعة من الآداب والفضائل التي ينبغي للطبيب التحلي بها، ويمكن التعبير عنها بكلمتين هما: الإخلاص والاختصاص. ويرى القره داغي ضرورة معرفة الطبيب بالأحكام الشرعية الخاصة بالطب والمريض. وفي ختام البحث، يشدد القره داغي على مسألة الحفاظ على سر المريض والمقصود به الحفاظ عما سمعه ورآه من المريض.

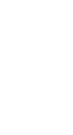
















إضافة تعليق جديد