![[مراجعة الدكتور: عبد المجيد النجار] مراجعة كتاب " الوراثة والإنسان" تأليف الدكتور: محمد علي الربيعي [مراجعة الدكتور: عبد المجيد النجار] مراجعة كتاب " الوراثة والإنسان" تأليف الدكتور: محمد علي الربيعي](/sites/default/files/resources/images/book-review.jpg)
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم عام
هذا الكتاب عنوانه الأصلي" الوراثة والإنسان " وعنوانه الفرعي "أساسيات الوراثة البشرية والطبية"، وهو من تأليف الدكتور: محمد علي الربيعي، أستاذ متخصص في علم الوراثة من علوم الحياة. وقد نشر سنة 1986 ضمن سلسلة "عالم المعرفة" التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت.
يتناول الكتاب بالبيان الوراثة البيولوجية بين الأجيال في الإنسان والحيوان والنبات، شرحا للحاملات الوراثية في الخلية وما تحمله من الصفات المورّثة، ثمّ ما يصيب تلك المورّثات وبالتالي تلك الصفات من تغيّر بفعل طبيعي أو بفعل إنساني، وما ينشأ عن ذلك التغيّر الذي يحدث في الإنسان خاصّة بفعل منه من أثر في فطرته يتبعه أثر في أبعاده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
والكتاب في مجمله وصفي علمي، يشرح الوراثة بين الأجيال الحية: ما هي معدّاتها الناقلة وما هي مضامينها المنقولة وماذا يطرأ على تلك المعدّات وتلك المضامين من تغيّر طبيعي أو مصنوع وما هي آثار ذلك ونتائجه، ولكنه يتطرّق في بعض القضايا إلى بيانات معيارية يتناول فيها المؤلف الأبعاد الأخلاقية والإنسانية لما يتدخّل فيه الإنسان من التغيير في المسار الوراثي فيكون له موقف معياري فيها.
مضى على تأليف هذا الكتاب ثلاثون عاماً، وهي بقياس تسارع الكشوفات العلمية مدّة طويلة، فقد حدثت خلال هذه المدّة في علم الوراثة تطوّرات هائلة وكشوفات واسعة؛ ولذلك فإنّ مراجعته ينبغي أن تكون من خلال سياقه الزمني وفي إطار ما انتهى إليه علم الوراثة زمن تأليفه.
أولاً ـ عرض محتوى الكتاب
قُسّم الكتاب إلى ستة عشر فصلاً، ويمكن إدراج هذه الفصول ضمن أربعة محاور أساسية، يتناول كلّ محور منها بالبيان قضية من القضايا المتعلقة بالوراثة.
المحور الأول: محامل الوراثة وحمولتها: الكروموزومات والجينات
إذا كنّا نشهد أنّ الكائن الحيّ إنساناً وحيواناً ونباتاً حينما يتوالد يأتي المولود منه مماثلاً للوالد في جنسه فإنّ ذلك يعود إلى محامل في التكوين الطبيعي لكلّ كائن مضمّنة في كلّ خلية من خلاياه تحمل من الخصائص والصفات ما يجعل المولود مماثلاً للوالد، وعلى قدر ما تحافظ تلك الخصائص والصفات على طبيعتها يكون التماثل، وعلى قدر ما يطرأ عليها من التغيير يكون الاختلال في التماثل بين الوالد والولد.
تسمّى تلك المحامل بـ"الكروموزمات" وعددها في كل خلية ثلاثة وعشرون زوجاً يأتي نصفها من بويضة الأم ويأتي نصفها الآخر من حيمن الأب، وتتشكل هذه الكروموزمات في شكل شريط طويل متلاصق.
على هذا الشريط تسجّل مجموعة كبيرة جداً من المعلومات التي تسمّى "جينات" تحدّد كلّ معلومة منها صفة من صفات الكائن الحيّ مثل الطول واللون والشكل والبصر والسمع وغير ذلك من الصفات والخصائص، وهذه المعلومات المسجّلة هي التي تجعل بحسب طبيعة كلّ منها هذا الكائن إنساناً وذاك حصاناً وذلك ثوراً إلى آخر الأنواع، وهي التي تجعل هذا الإنسان أبيص وذاك أسود وذلك طويلاً وغيره قصيراً إلى آخر الصفات.
يتكون هذا الشريط المزدوج من التلاقح بين الذكر والأنثى بالتناصف، ثم ينتقل إلى كلّ خلية من خلايا الجسم عند انقسامها بالأنواع المختلفة من الانقسام، فإذا كلّ خلية من خلايا الجسم تشتمل على هذا الشريط/ الكروموزوم مسجّلاً عليه صفات وخصائص الكائن الذي ينبني جسمه من تلك الخلايا.
وحينما يولد مولود جديد من الاتصال بين ذكر وأنثى فإنّ التلقيح الذي يحصل بين بويضة الأنثى وحيمن الذكر يتكوّن فيه شريط الكروموزوم بالتناصف بين الطرفين ليحمل هذا الشريط المعلومات/ الجينات من الوالدين إلى الولد فيكون مماثلاً لهما بما ورث عنهما من الخصائص والصفات التي تحددها المعلومات المسجلة على الكرموزومات، وهكذا تتالى الأجيال تباعاً.
المحور الثاني: الحمولة الوراثية
ما هو مضمون هذه المعلومات/ الجينات المسجلة على شريط الكروموزوم والتي تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل؟ إنه مضمون ثري جداً، يشمل كلّ ما يكون به المولود مماثلاً لوالده سواء في أصل جنسه فلا يكون جنساً غيره، أو في صفاته وخصائصه في نطاق الجنس الواحد. ويتمثّل ذلك بالأخصّ فيما يلي:
أ ـ وراثة الصفات
إنّ الجينات المثبتة على شريط الكروموزمات هي خزان لكمّ هائل من المعلومات متمثّلة في خصائص وصفات وفي أمراض وتشوّهات فيما يشبه البرمجة التي نودعها في الحاسوب، وهي تقوم بنقلها من جيل إلى جيل، وهي وإن كانت ناقلة على وجه التواتر إلا أنّ تواترها في التوريث لا يكون منتظماً باطّراد بل تحدث أحياناً طفرات يتغيّر بها الجين الناقل لصفة معيّنة أو مرض معيّن عن طبيعته، فيتغيّر معه التوريث فلا تظهر تلك الصفة أو ذلك المرض في الأبناء، وليست لهذه الطفرات أسباب معروفة، غير أنّ تغيّرات بيئية قد تكون سبباً في ازدياد نسبة الطفرات مثل التعرّض للأشعّة السينية، وللطاقة الذرية، ولموادّ كيميائية أخرى.
تحمل الكروموزمات جينات مختصّة في نقل الصفات من الآباء إلى الأبناء، فيكون بمقتضاها الأبناء على شبه بآبائهم، ومن تلك الجينات الناقلة للصفات تلك التي تنقل صفة الجنس من ذكورة أو أنوثة، والجينات التي تنقل لون البشرة ولون العيون، والجينات التي تنقل طول القامة، وكذلك الأمر في توريث صفات أخرى كثيرة.
ب ـ وراثة العاهات
وفي نطاق هذا التوريث للصفات بما تنقله الجينات فإنّ التوريث يكون أيضاً للعاهات والتشوهات، وذلك عن طريق جينات خاصّة بها، فثمّة على سبيل المثال جينات تنقل مرض القزامة، وجينات تنقل مرض نزيف الدم، وجينات تنقل مرض فقدان إنزيم الكلوكوز، وأخرى تنقل الصلع، وهكذا فإنّ أمراضاً كثيرة تنقلها جينات معيّنة من جيل إلى جيل.
إنّ ثمّة علاقة وطيدة بين الأمراض والجينات، فهناك جينات معينة مسؤولة عن أمراض محدّدة مثل الأمراض السرطانية وأمراض انفصام الشخصية، وإذا كانت الدراسات لم تتوصّل إلى نتائج حاسمة في دور هذه الجينات وما تحمله من أمراض في التوريث فإنّ هناك مؤشّرات كثيرة على أنّ للجينات دوراً في توريث هذه الأمراض، ومن ذلك على سبيل المثال الاستعداد الوراثي للإصابة بمرض ما من هذه الأمراض حينما يكون في الأسرة من هو مصاب به.
ج ـ وراثة الدم والمناعة
يختلف تركيب الدم بين شخص وآخر، وذلك بسبب أنّ هذا التركيب يتنوّع إلى أربعة فصائل موزّعة بين بني الإنسان، ويعود هذا الاختلاف إلى تعدّد في الجينات الحاملة لهذه الفصائل، فكلّ فصيل مسؤول عنه جين معيّن ينتجه وينقله من جيل إلى جيل، وبسبب دقّة هذا التوريث وانتظامه أصبح اليوم معرفة نسبة هذا المولود إلى هذا الوالد معرفة يقينية أو شبه يقينية، فأصبحت هذه المعرفة تستخدم في القضاء لتحديد الأنساب وللتحقيق في الجرائم.
ويشتمل الدم بفصائله المختلفة على جهاز للمناعة يتكفّل بمهاجمة الفيروسات والجراثيم وكلّ الأجسام الغريبة التي تغزو الجسم، ويتّصف هذا الجهاز في تركيبه وفي الدور الذي يقوم به بقدر كبير من التعقيد غير أنّ للجينات الوراثية دوراً مهمّاً في هذا الجهاز المناعي، فهناك جينات مسؤولة عن إنتاج بعض العناصر والخلايا التي تقوم بدور هامّ في التصدّي للأجسام الغريبة، ولا شكّ أنّ لذلك تعلّقاً بالتوريث فيما يخصّ الجهاز المناعي.
المحور الثالث: التدخّل الإنساني في التوريث الجيني
إنّ الكروموزمات وما تحمله من جينات قد تكون في وضع طبيعي سليم، فيتمّ التوريث على نسق طبيعي، ولكن قد تتعرض لتغيّرات تُفقد فيها بعض الكروموزمات أو تُفقد فيها أجزاء منها، وهو ما يؤدّي بطبيعة الحال إلى تغيّرات في حمولتها من الجينات الوراثية بفقدان الكروموزمات التي تحملها أو بتعرّضها لتلف أجزاء منها، وهو ما يكون له الأثر البالغ في عملية التوريث، إذ تحيد هذه العملية عن البرنامج المعدّ في الحالة الطبيعية، ويتمثّل ذلك بالأخصّ في حدوث تشوّهات في الأجنّة قد تكون مرعبة أحياناً مثل التخلّف العقلي أو فقدان بعض الأعضاء الأساسية من أعضاء الجسم.
وإذا كانت بعض هذه التغيّرات في الكرموزومات وما تحمله من جينات تحدث بصفة خارجة عن الفعل الإنساني مثل العوامل الطبيعية والبيئية، فإنّ بعضاً آخر منها يحدث بفعل التدخّل الإنساني، فالعقاقير الطبية من مضادّات حيوية ومهدّئات وعقاقير السرطان والصرع، وكذلك التدخين والمشروبات الكحولية لها كلّها دور في التغيّرات التي تطرأ على الكروموزمات وحمولتها من الجينات، ويتبع ذلك تأثير في المسار الوراثي يظهر غالباً في تشوهات في الجيل الوارث من حيث أريد العلاج للجيل المورّث.
وبالإضافة إلى التدخّل الإنساني في مسار التوريث بالتدخّل في المورّثات عن حسن نية كما هو الأمر في العقاقير الطبية فإنّ ثمّة تدخّلاً إنسانياً آخر في المسار الوراثي على سبيل العمد أو شبه العمد، وذلك مثل تعريض الناس لبعض الأشعة مثل الأشعة المؤينة والأشعة النووية، إهمالاً وتقصيراً أو اتخاذها أسلحة حربية، فإن هذا التدخّل الإنساني يحدث طفرات في النسق الجيني، أو بتعبير آخر في البرمجة الجينية، تنتج عنها آثار وراثية مرعبة، وقد ثبت أنّ القنابل النووية التي أُلقيت على هيروشيما ونجزاكي أدّت إلى تشوّهات كبيرة في الجيل الذي ولد بعد تلك الحادثة للتغييرات الجينية التي أحدثتها القنابل النووية المشعّة. وربّما اندرج ضمن هذا السياق تلك المحاولات التي استهدفت اختيار جنس المولود ذكراً وأنثى بتدخّل جيني يغيّر من المسار الوراثي الطبيعي.
على أنّ أخطر هذه التدخّلات الإنسانية في المسارات الوراثية هو ما أصبح يسمى بالهندسة الوراثية التي يتدخّل فيها الإنسان في الجينات الوراثية بالتغيير في تركيبها، وبتركيب أصناف جديدة منها، إما لتلافي تشوهات وأمراض أو لتخليق أنواع جديدة من النباتات والحيوانات تكون أسلم كياناً وأغنى مورداً للإنسان.
المحور الرابع: المستقبل الوراثي
إنّ الدراسات المتعلّقة بالتدخّل الإنساني في النظام الوراثي عبر الهندسة الوراثية ما زالت في بداياتها ولكنها تفتح على تطوّر هائل لا يعرف منتهاه في مستقبل الطبيعة، فالتغييرات في أصناف النبات والحيوان وإن ل بدا في الظاهر أنه في خدمة الإنسان إذ يوفّر المحصول الأسلم والأوفر، فإنه لا يعرف تأثيره على التوازن البيئي الذي تدبّر به الطبيعة نفسها دون تدخّل الإنسان، كما لا يُعرف مدى ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التدخّل من استحداث وسائل للدمار تستعمل في الحروب.
فإذا ما وصل هذا التدخّل الإنساني في النظام الجيني إلى دائرة الإنسان فإنّ المستقبل ينطوي في شأنه على احتمالات متقابلة، فما إن يتبادر إلى الذهن أنّ الهندسة الوراثية في شأن الإنسان ستخلّص الإنسان من كثير من الأمراض، إذ أننا " ننشأ حاملين عالماً وراثياً صغيراً معنا يضعنا في طريق فريد من نوعه، إلا أننا نحمل معنا إلى هذا العالم نواقصنا وعللنا"[2] وستساعدنا الهندسة الوراثية على التخلّص من هذه النواقص والعلل، ما إن يتبادر ذلك إلى الذهن حتى نتصوّر مستقبلاً مأساوياً قد ينتظر وجود الإنسان بما قد ينتهي إليه هذا التدخّل الإنساني في النظام الجيني للإنسان من تخليق إنسان ليس هو هذا الإنسان الموجود على الأرض وفي ذلك ما فيه من المخاطر على الوجود الإنساني.
ثانياً ـ تقييم الكتاب
1 ـ الكتاب في إطاره الزمني
مرّ على تأليف هذا الكتاب ثلاثون عاماً، وهي مدّة طويلة بالنظر إلى تسارع الكشوفات العلمية بصفة عامّة والكشوفات العلمية في المجال الجيني بصفة خاصّة، فالخارطة الجينية وقع في اكتشافها تقدّم كبير خلال هذه الثلاثين سنة، والاستنساخ الجيني تطوّر تطوّراً كبيراً انتهى إلى استنساخ النعجة دوللي وهو يتّجه إلى استنساخ الإنسان لولا الكوابح القانونية والأخلاقية، ولعلّ بعض المحاولات في ذلك تقع في الخفاء.
إنّ المعلومات التي يشتمل عليها هذا الكتاب ذات أهمّية بالغة في الزمن الذي أُلّف فيه، وهي ذات أهمية بالنسبة لعامّة المثقفين من غير المختصّين، ولكنها بالنسبة لعلوم الجينوم كما هي اليوم قد تجاوز الزمن كثيراً منها، فكم من فكرة أو فرضية في الكتاب أوردها المؤلّف على أنها من الخيال العلمي أصبحت اليوم حقيقة واقعة؛ ولذلك فإن مراجعة هذا الكتاب ينبغي أن تكون مراجعة محكومة بالإطار الزمني الذي أُلّف فيه.
2 ـ البناء المنهجي للكتاب
بُني الكتاب على فصول متوازية عددها ستة عشر فصلاً، وذُيّل بقائمة في المصطلحات وبقائمة في المراجع الرئيسية، وبملحق ببعض الرسوم، مع مقدّمة استهلالية في الصدارة. وإذا ضممنا الفصول إلى بعضها وجدناها تتمحور في أربعة محاور كبرى: يتعلق الأول بشرح البنية المادّية في الجسم التي تحمل مؤهّلات الوراثة، ويتعلّق الثاني بوراثة الصفات والتشوهات في الوضع الطبيعي، ويتعلق الثالث بالتدخل الإنساني في التغيير الجيني وآثاره، ويتعلّق الرابع بالمضامين الاجتماعية للتغيرات الجينية وآثارها على مستقبل الإنسان.
وقد وردت فصول الكتاب بصفة عامّة على هذا الترتيب دون إدراجها في أقسام أو محاور، غير أنّ بعضاً منها يبدو أنّ إدراجه كان إدراجاً استطرادياً ليست له صلة واضحة بالفكرة الأساسية للكتاب وهي وراثة الإنسان، أو أنّ تلك الصلة لم يقع بيانها بالقدر الكافي، وهو ما يبدو واضحاً في الفصل المتعلّق بالتوأم والفصل المتعلّق بأطفال الأنابيب.
ليس في الكتاب تفرقة واضحة بين ما هو تأثير وراثي جيني من فعل الطبيعة وبين ما هو من فعل الإنسان سوى ما خصّصه من فصل للهندسة الوراثية باعتبارها هندسة من فعل الإنسان، ولكن في فصول أخرى عديدة يختلط ما هو تأثير طبيعي وما هو تأثير إنساني، وما يذكر من التأثيرات الإنسانية لا يوضع في وضعه الطبيعي من احتمالية ما قد ينتج عنه من الأهوال، وفي هذا السياق ورد في الكتاب الآثار الجينية الوراثية للقنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما ونجزاكي في نفس السياق الذي وردت فيه الآثار التي تحدثها بعض الأدوية بالأشعة كالتهاب المفاصل أو التي تظهر على عمال المناجم، وربما كان من الموفّق لو فصل المؤلّف بوضوح بين المسارات الوراثية التي تكون بفعل الطبيعة وبين المسارات التي تكون بالفعل الإنساني.
3 ـ الأسلوب في الكتاب
يتّجه هذا الكتاب بالخطاب إلى عامّة المثقفين كما هي الغاية من السلسلة التي نشر فيها، ولم يكن من غرضه أن يتّجه إلى المختصّين من العلماء؛ ولذلك فإنّ الأسلوب الذي حرّر به هو في عمومه أسلوب ميسّر للفهم من قِبل عامّة القرّاء المهتمّين بهذا الموضوع وأشباهه، غير أنّ بعض الفصول من الكتاب تحيد عن هذا السمت الأسلوبي العامّ وتغرق في التفصيل الدقيق والمصطلحات الفنية المختصّة فتستعصي إذن عن الفهم بالنسبة لعامّة القرّاء.
يجد القارئ العادي في الفصول الأولى من الكتاب صعوبة في متابعة النسق العلمي الذي يبنيه المؤلّف، ولعلّ ذلك يعود على نحو أو آخر إلى طبيعة المادّة العلمية التي تناولتها هذه الفصول، فهي تشرح التكوين الطبيعي للخلية وما تشتمل عليه من كروموزمات وما تحمله من جينات، وتغرق في شرح التركيب الكيميائي لهذه المكوّنات وإيراد المصطلحات المتعلّقة بها، وكلّما اقتربت هذه المادّة العلمية في الفصول التالية من الأبعاد الوظيفية والاجتماعية أصبحت أيسر أسلوباً وأقرب إلى فهم عامّة القرّاء.
4 ـ قضايا للمناقشة
ورد في الكتاب أفكار عديدة، بعضها كلّي وبعضها جزئي، تحتاج إلى وقفة حوارية للمناقشة لما يُرى فيها من غموض أو من مخالفة للقيم الأخلاقية والدينية، أو غير ذلك مما يقتضي الوقوف عندها؛ ولذلك فإننا نورد تالياً بعض هذه الأفكار ونعرضها عرض مناقشة ونقد.
أ ـ التدخّل الإنساني في النظام الجيني
يبدو المؤلّف متحمّساً للتدخّل الإنساني في النظام الجيني سواء في المجال النباتي والحيواني أو في المجال الإنساني، فهذا هو سمته العامّ في كتابه وإن كان يبدي أحياناً بعض التخوّفات والاحترازات في شكل تساؤلات يلقيها بين الحين والآخر ولا يجد لها جواباً في الوقت الراهن، ولكنه يعلّق آمالاً على أنّ تلك التساؤلات سيجد لها العلم المستقبلي جواباً في المستقبل، فهي إذن تساؤلات فنية علمية وليست تساؤلات في جوهر التدخّل الإنساني ومآلاته المستقبلية.
يقول المؤلّف فيما يتعلّق بالهندسة الوراثية في الحقل النباتي والحيواني "إنّ تطوّر الطرق الفعالة للسيطرة على عمل الجينات سيؤدّي بلا شكّ إلى إيجاد أساليب جديدة للتغلّب على مختلف المشاكل الزراعية والطبية. لقد أصبحت الوراثة في يومنا هذا حقلاً متميزاً للتطبيقات الفيزيائية والكيميائية والرياضية في سبيل إيجاد طرق نوعية جديدة للسيطرة على توارث الكائنات الحية وتسخير هذا التوارث لخدمة الإنسان"[3]
إنّ التساؤلات التي يلقيها المؤلّف في هذا الصدد مقتصرة على ما يثار من "إمكانية هروب بكتيريا أو فيروس مميت من المختبر بعد تكوينه، وما يؤدّي إليه ذلك من انتشار وباء لا يعرف الإنسان كيفية القضاء عليه"[4]، ثم يعقّب على ذلك بقوله: " يظهر أنّ الخطر الوحيد من الهندسة الوراثية هو إمكانية استخدامها عسكرياً لإنتاج مختلف الأسلحة الجرثومية الفتاكة"[5]. إنها تساؤلات واحترازات مهمّة، ولكنها وضعت في حيّز جزئي يتعلّق بالخطأ الإنساني الأخلاقي أو الفني الذي يمكن جبره بتلافي الأخطاء تقدّماً في العلم أو تقدّماً في يقظة الضمير الأخلاقي. إنّ التدخّل الإنساني في النظام الجيني النباتي والحيواني بطريقة مفتوحة قد يؤدّي إلى أخطار أكبر بكثير من الأخطار التي أوردها المؤلّف، وهي أخطار لا يمكن تلافيها حتى وإن تقدّم العلم واستيقظ الضمير.
إنّ البيئة الطبيعية تسير على منطق خاصّ بها تترتّب فيه خواصّها ومكوّناتها وتفاعلاتها وتطوّراتها بطريقة يتحقّق فيها التوازن البيئي، وما يحصل فيها من أعطاب هنا وهناك وفي هذا الظرف أو ذاك يقدر منطقها الذي بُنيت عليه بتقدير إلهي عند المؤمنين وبقدرة ذاتية عند غيرهم على أن يصلح تلك الأعطاب فتعود الطبيعة إلى توازنها. أما إذا تدخّل الإنسان كعامل خارجي عن نسقها العادي بمقتضى عقله وإرادته الحرّة لا بمقتضى ما هو متساو فيه مع سائر الكائنات من تلبية حاجاته الأساسية فإنّ تدخّله هذا في النظام الجيني الذي قد تختفي فيه أنواع وتستحدث فيه أنواع أخرى من النباتات أو الحيوانات بغية توفير كمالات للإنسان لم توفّها له الطبيعة يحمل إمكانية كبيرة في أن يؤدّي إلى خلل في توازن البيئة ينتهي بفقدان قدرتها على إعالة الحياة فتنقرض هذه الحياة.
إنّ البيئة الطبيعية خلقت على قدر كبير من الحساسية من التدخّل الخارجي في نظامها، وها نحن نرى كيف أنّ التدخّل الإنساني الذي يرفع من الحرارة في الأفق الأرضي درجتين أو ثلاثاً أدّى إلى ما أدّى إليه من تغيّر مناخي ينذر إذا ما تمادى بكوارث قد تأتي على الحياة بالفناء، فكذلك الأمر إذا ما انقرضت أنواع من النبات والحيوان أو استحدثت أنواع أخرى بفعل التدخّل الإنساني في النظام الجيني، فإنّ لكلّ نبات بمواصفاته، ولكلّ حيوان بخصائصه دوراً في حفظ التوازن البيئي، واختفاؤه أو استحداث غيره بتدخّل خارجي من الإنسان بطريق ما أصبح يسمّى بالهندسة الوراثية ستعتبره الطبيعة اعتداء عليها من جنس الاعتداء عليها بالرفع من درجة الحرارة الأرضية أو التهتيك في الطبقة الأوزونية مثلاً، وستقابله إذن بردّ فعل انتقامي عنيف مثل ما ترسل من نذر تتمثّل في الكوارث التي تحدث بين الحين والآخر أعاصيرَ وفيضانات وموجات جفاف. وإذ لم يحدث شيء من ذلك بسبب اختفاء جنس الدناصير العملاقة مثلاً فلأنّ ذلك الاختفاء من تدبير الطبيعة وليس من تدبير الإنسان.
وحينما يتعلّق الأمر بالتدخّل الإنساني في النظام الجيني للإنسان فإنّ المؤلّف يعرض بعض المحاولات التي تقع في هذا السبيل، ولكنّه يعرضه عرضاً حيادياً دون اتّخاذ موقف منه، فهو يكتفي بالتساؤل إن كانت الهندسة الوراثية في الكيان الإنساني شيء جيّد أم سيّء، وحينما تعرّض إلى طموح بعض العلماء في تخليق الإنسان السوبر مان اكتفى في التعليق على ذلك بأنّ طموحهم ما زال خرافة تجدها في عقولهم وكتبهم لأنّ الأسس البيولوجية لذلك ما زالت غير معروفة، والاكتفاء بهذا التعليق يوحي بأنّه لا يرى مانعاً من تخليق الإنسان السوبر مان إذا ما تقدّم العلم وأصبح يمكّن من تحقيق هذا الهدف [6].
لقد جاءت الأديان والنظم الأخلاقية تحمّل الإنسان التكاليف والمسؤوليات الدينية والأخلاقية على أساس طبيعته التي هو مخلوق عليها في وضعه الحالي، وذلك على قدر قوّته وضعفه في جسمه وعقله ومشاعره وإرادته، فإذا ما أصبح إنسانا سوبر مان يتّصف من الصفات بما هو أعلى بكثير من الصفات التي يتّصف بها الآن فكيف سيكون مطالباً بنفس التكاليف التي هو مطالب بها الآن في حدود طبيعته الحالية كما خاطبته بها الأديان والنظم الأخلاقية؟ إنّ ذلك سيؤدّي حتماً إلى هدم ما عرفته البشرية من نظم دينية وأخلاقية لأنها لم تصبح صالحة لهذا النوع الجديد من الإنسان، وهو الأمر الذي لم ينبّه إليه المؤلّف.
ب ـ الوراثة والتطوّرية
لم يصرّح المؤلّف في جزم بأنّ الإنسان مندرج ضمن السلسلة التطوّرية للحياة كما هي عند داروين وأتباعه، ولكنّ بياناته في أكثر من موضع من كتابه توحي بأنه يميل إلى ذلك، فهو يقول على سبيل المثال:" لقد منحنا علم الوراثة نظرة جديدة لتاريخ الحياة والإنسان، فنحن نعلم اليوم علم اليقين أننا لسنا إلا جزءاً من هذه الحياة، وأن جذورنا هي جذور الحياة ...نحن نملك جينات مشتركة مع كلّ أنواع الحياة القديمة والحاضرة، مع كلّ أنواع الكائنات الحية التي وجدت على هذه الأرض"[7].
ولا يخفى ما في هذا الميل للاعتراف بالتطورية بالنسبة للإنسان من مجازفة، وذلك بالنظر إلى الانتقادات المتسارعة المتوجّهة إلى هذه النظرية، والكشوفات المتتالية التي تفضح التزييف في الأدلّة التي أقامها القائمون بها عليها، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يؤخذ في الحسبان عند تناول ما يتعلّق بالتّطورية في الحقل الإنساني.
ج ـ الوراثة والجريمة
تعرّض المؤلّف إلى التكوين الجيني في الإنسان وعلاقته بالجريمة، وذكر أنّ بعض الناس يولدون بنظام كروموزومي فيه زيادة عن المعتاد مما يسبّب لهم زيادة في الشدّة والغلظة، وهو ما " أدّى إلى تبرئة ساحة كثير من المجرمين على أساس تركيبهم الكروموزومي فلا سلطان لهم على تصرّفاتهم"[8]، أورد المؤلّف ذلك دون تعليق مما يوحي بأنه موافق عليه.
ولا يخفى ما في فتح هذا الباب في الإعفاء من الجريمة من خطورة، إذ هو باب لإسقاط التكاليف على من اشتمل تركيبه الجيني بعض التغيّر بالنسبة للتركيب العادي، وهو باب قابل للتوسّع الذي قد ينتهي إلى الفوضى بتوسيع أبواب التبرئة للمجرمين. والحاكم الفيصل في هذا الشأن هو ما يتمتّع به الإنسان من عقل راشد ومن إرادة حرّة، فعلى أساسهما في حال الوجدان تقام التكاليف وعلى أساسهما تسقط في حال الفقدان.
د ـ اختيار جنس الوليد
أورد المؤلّف الإمكانية في اختيار جنس الوليد ذكراً أم أنثى بالتدخّل في النظام الجيني للإنسان، وذكر بعض المحاولات الواقعة في هذا السبيل مشيراً إلى أنّه لا توجد طريقة مضمونة لتحديد جنس الوليد، ولم يبد تعليقاً على ذلك مما يوحي بأنه لا يرى منه مانعاً إذا ما تقدّم العلم في الطرق التي تحقّقه مستقبلاً[9].
ولا يخفى ما في هذا التدخّل الجيني لاختيار الجنس من أخطار، فالتدبير الطبيعي قدراً من عند الله عند المؤمنين وقوّة طبيعية عند غيرهم أفضى إلى تعادل طبيعي بين عدد الذكور وعدد الإناث بحيث لا يتفاوتان إلا بالقدر القليل جداً الذي لا يؤثّر على التوازن في النمو البشري، فإذا ما أصبحت هذه النسبة رهينة رغبة الإنسان في أن تولد له الذكور أو الإناث فإنّ ذلك يشكّل خطراً على المستقبل الإنساني، إذ هذه الرغبة قد تميل إلى هذا الجنس أو ذاك بحسب الظروف التي تتقلّب فيها المجتمعات من سلم وحرب ومن فقر وغنى، وحينما تنخرم هذه النسبة انخراماً كبيراً فإن ذلك يكون له أثره المدمّر على نموّ النوع الإنساني نمواً طبيعياً، وعلى الأنظمة الاجتماعية التي تقوم على النسبة القدرية المتوازنة.
ه ـ تقييم عامّ
إنّ القارئ لهذا الكتاب من غير المختصّين في موضوعه على وجه الخصوص يجد فيه فوائد كثيرة فيما يتعلّق بالنظام الوراثي القائم على النظام الجيني، وإن كان المتتبّع للأخبار العامّة المتعلّقة بهذا الشأن يلاحظ أنّ تطوّراً كبيراً يحدث فيه بالنسبة لما يورده المؤلّف، وهو ما يبرّر ملاحظتنا السابقة بأن هذا الكتاب يجب أن يوضع في إطاره الزمنيّ وأن تكون مراجعته على ذلك الأساس.
ويحاول المؤلّف أن يلتزم الموضوعية في عرض ما يعرض وفي نقل ما ينقل من الأفكار والتجارب، وإذا ما كان له من تعليق أحياناً فإنه يكون في الغالب تعليقاً غير مباشر مع ميل إلى مسايرة منتهيات الهندسة الوراثية في المجال النباتي والحيواني وفي المجال الإنساني أيضاً، وإذا ما كان له من احتراز فإنه يكون احترازا في المآلات الاجتماعية من تفاوت طبقي أو صراع عسكري بسبب استغلال التغييرات الجينية في تخليق ثروات أو أسلحة تمكّن من ذلك.[10] أما الأخطار الجوهرية التي يحدثها التدخّل الإنساني في النظام الجيني للإنسان خاصّة وللنبات والحيوان أيضاً فلم يعرها المؤلّف الاهتمام اللائق بها، والحال أنها هي جوهر البحث في هذا الموضوع.
ثالثاً ـ علاقة الكتاب بمشروع البحث
إنّ مشروع البحث الذي تندرج هذه المراجعة ضمن فعالياته، يهدف إلى توطين علم الجينوم في الخليج العربي خاصّة والوطن العربي عامّة بأخلاق طبية تنسجم مع التوجيهات الإسلامية، فيكون إذن علماً خالياً مما عسى أن يكون فيه من ممارسات في النظام الجيني تتعارض مع التعاليم الإسلامية في ذاتها أو في آثارها ومآلاتها، فهذا العلم نشأ في بيئة ثقافية غربية تبيح أحياناً ما لا يبيحه الإسلام من الممارسات المتعلّقة بالكيان الإنساني بل وبالكيان النباتي والحيواني.
وبما أنّ هذا الكتاب يشرح علم الجينوم كما هو في البيئة الغربية بخصائصها الثقافية، وما يتمّ فيه من تدخّل إنساني في النظام الجيني الحيواني والنباتي والإنساني فإنّه يكون ذا علاقة مباشرة بمشروع البحث الذي تندرج مراجعة هذا الكتاب ضمن برنامجه. وتبدو هذه العلاقة في جملة من النقاط والقضايا التي تلتقي فيها الدراسة التي يشتمل عليها الكتاب، كما تبدو في جملة من التساؤلات والإشكاليات التي يطرحها هذا الالتقاء بين الطرفين في الموضوع وتطلب جواباً أخلاقياً إسلامياً يحقّق الهدف من المشروع.
1 ـ مسائل مشتركة بين البحث والمشروع
إذا تجاوزنا ما ورد في هذا العمل من بحث وصفي للتكوين الجيني في ذاته وتطوراته وتفاعلاته كما اشتملت عليه الفصول الأولى من الكتاب خاصّة، فإننا نجد قضايا عديدة من التدخّل الإنساني في الجينوم ذات علاقة بالتعاليم الإسلامية في التعامل مع المخلوقات في نطاق البيئة الطبيعية وفي النطاق الإنساني خاصّة. ومن أهمّ هذه القضايا نذكر ما يلي:
أ ـ التدخّل الإنساني في النظام الجيني للنبات والحيوان
ب ـ التدخّل الإنساني في النظام الجيني للإنسان
ج ـ الإجهاض نتيجة لمعلومات جينية تشير إلى مصير الأجنّة
دـ ـ اختيار جنس المولود بالتصرّف في النظام الجيني
ه ـ الهندسة الوراثية من أجل تخليق الإنسان السوبر مان
2 ـ إشكالات وتساؤلات يثيرها الكتاب
إنّ ما هو مطروح في هذا البحث في علاقته بالتعاليم الإسلامية يثير العديد من الإشكاليات والتساؤلات التي تطلب جواباً شرعياً حتى يكون العلم الجيني علماً متصفاً بالأخلاق الطبية الإسلامية. ومن أهمّ تلك الإشكالات والتساؤلات ما يلي:
- إذا كان التدخّل الإنساني في النظام الجيني للحقول النباتية والحيوانية إنما هو من أجل تسخير هذه الحقول لمصلحة الإنسان وتوفير أسباب الرفاه له فهل يفضي هذا التدخّل الإنساني الواسع في هذا النظام الجيني إلى خلل في التوازن البيئي الذي قدّرت فيه الموجودات على طبيعتها الحالية لحفظ هذا التوازن واستمرارية الحياة على أساسه؟
- ما هي الضمانات في أنّ المنتهيات التي تنتهي إليها المعالجة الجينية للنبات والحيوان حتى وإن حقّقت بعض الخير للإنسان لا تؤول إلى أسلحة فتاكة في الصراع بين بني الإنسان والحال أنّ هذا الصراع يحتدم بين الأمم يوماً بعد يوم من أجل السيطرة على المقدّرات العالمية؟
- إذا كان التدخّل الإنساني في النظام الجيني للإنسان يهدف إلى معالجة التشوّهات الطارئة عليه فهل من ضمان لئلا تؤدّي تلك المعالجة الجينية إلى تشوّهات أخرى غير منتظرة وربما تكون أفظع من التشوهات المراد علاجها؟
- كيف يجوز الإجهاض بناء على معلومات جينية قد لا تستبين إلا بعد تخليق الجنين إنساناً والحال أنّ في الإسلام خاصّة وفي الأديان عامّة تشديد على احترام الحياة الإنسانية منذ الحياة الجنينية وفي ذلك تحديدات معلومة في فتاوى المجامع العلمية العالمية؟
- ما هو مصير الإنسانية إذا أرسل الأمر للناس من خلال المعالجة الجينية لاختيار جنس المولود ذكراً أو أنثى وانتهى الاختيار إلى انخرام في التوازن بين الجنسين كما هو محفوظ بالاختيار القدري في الوضع الحالي؟
- إذا تقدّمت البحوث الجينية بحيث تنتهي إلى تخليق الإنسان السوبر مان المتفوق في قدراته على الإنسان الحالي ما هو مصير الأنظمة الدينية والأخلاقية السائدة الآن والتي أُعدّت على أساس أن يُكلّف بها الإنسان بحسب قدراته وطاقاته في وضعه الطبيعي الحالي، إنها تصبح إذن غير صالحة لهذا الجنس الإنساني المتفوق؟
- أسئلة عديدة من هذا القبيل يطرحها قارئ هذا البحث من خلال الهدف الذي يطرحه مشروع توطين علم الجينوم في الخليج العربي بأخلاق طبية إسلامية، وهي تساؤلات أُثير بعضها في الدوائر الشرعية مثل المجامع الفقهية العالمية، وجاءت فيها فتاوى محددة مثل ما هو الأمر في الإجهاض وفي اختيار الجنس، وهي فتاوى ذات طابع جزئي في الغالب ولا تتعرّض للأسئلة الكبرى المتعلقة بالمصير البيئي والإنساني جراء التدخّل الإنساني في النظام الجيني للمكوّنات البيئية الحيّة، وهو ما يستلزم فيما نقدّر التوجّه إليه بالنظر الشرعي العميق من أجل تحديد الرأي فيه.
هذا وقد تناولت هذا الموضوع بالبحث دراسات أخرى من منطلق علمي وصفي ولكن بخلفية أخلاقية دينية، فوضعت أسئلة في غاية الأهمية من شأنها أن تنير السبيل في توجيه علم الجينوم توجيهاً أخلاقياً إسلامياً. ونذكر من ذلك على سبيل المثال دراسة أُنجزت في العهد الذي أُنجز فيه هذا البحث محلّ المراجعة ولكنها كانت أكثر انتباها إلى الإشكالات التي طرحنا منها آنفا بعض الأمثلة، وقد أنجز تلك الدراسة الدكتور عبد المحسن صالح وضمنها في كتاب بعنوان "التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان"، وقد نشر ضمن سلسلة " عالم المعرفة" برقم 48 سنة 1981.
والله ولي التوفيق
[1] تمت كتابة هذ البحث في إطار المشروع البحثي "توطين علم الجينوم في الخليج العربي: سؤال الأخلاق الطبية الإسلامية (Indigenizing Genomics in the Gulf Region (IGGR): The Missing Islamic Bioethical Discourse)" بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والمسجل برقم NPRP8-1620-6-057. وقد تمت المراجعة النهائية للنص من قِبَل أ. نور جاسر، مساعدة أبحاث بمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق وطالبة الماجستير (تخصص الفكر الإسلامي والأخلاق التطبيقية) بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة.
[2] محمد علي الربيعي ـ الوراثة والإنسان: 168
[3] نفس المرجع: 164 ـ 165
[4] نفس المرجع: 164
[5] نفس المرجع:166
[6] نفس المرجع: 165
[7] نفس المرجع: 167
[8] نفس المرجع: 87
[9] نفس المرجع: 141
[10] راجع في ذلك مثلا: نفس المرجع: 162،166

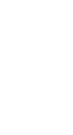
إضافة تعليق جديد