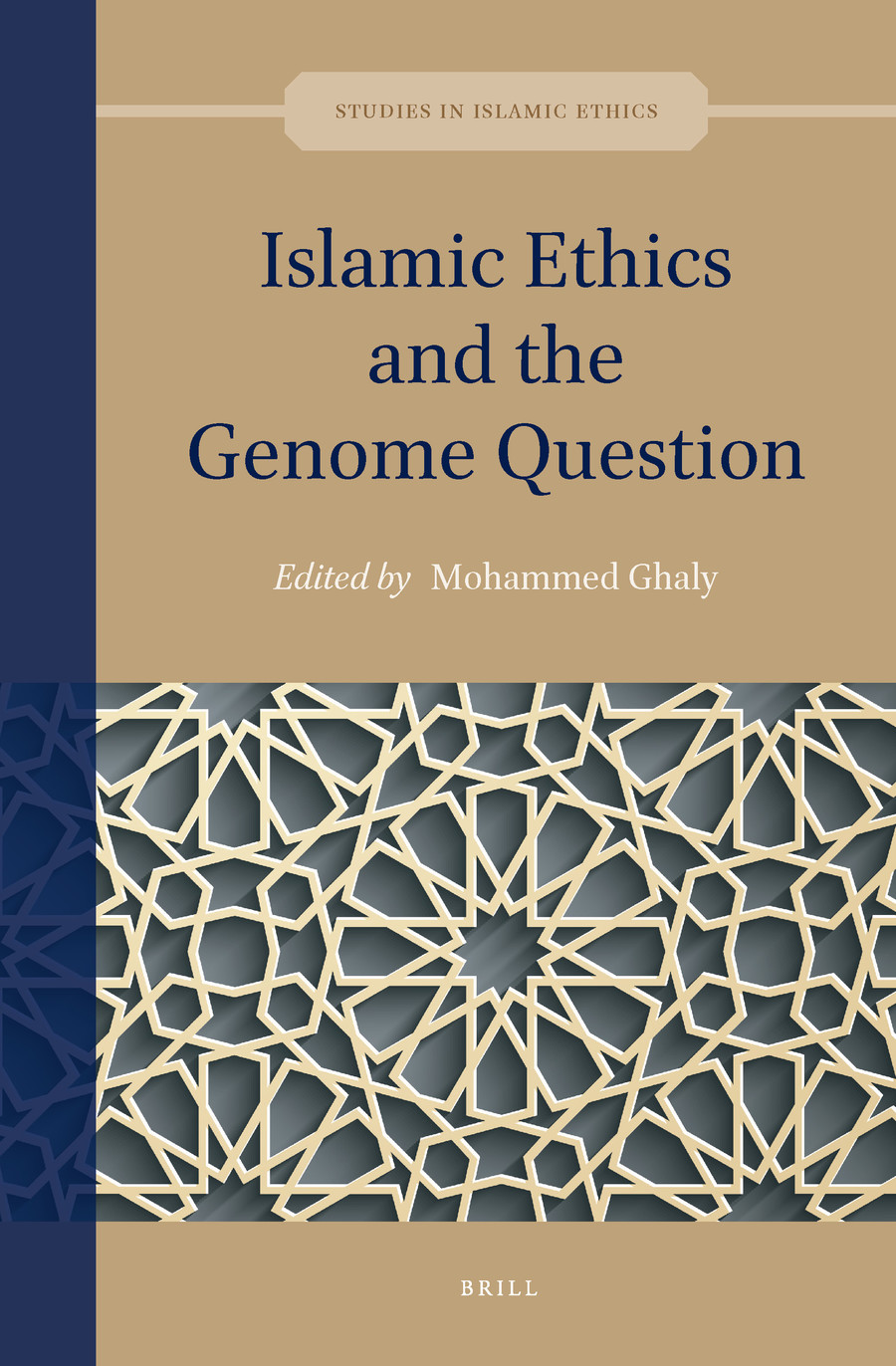
الأسئلة التي وردت في خطاب الدعوة:
"واجه العقل الفقهي المعاصر - فيما يبدو- صعوبات في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجينوم البشري من المنظور الفقهي (من أي مدخل وكيف تخرج هذه القضايا على الفروع والسوابق الفقهية والنصوص الشرعية). والسؤال:- لماذا كانت هذه الصعوبات في موضوع الجينوم البشري تحديدا؟ وما أهم الملاحظات المنهجية التي يمكن رصدها في هذا الشأن؟ وما أهم المسائل المتفق عليه والقضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث". أجوبة هذه الأسئلة في أغلب الظن (ومن غير قطع)، تظهر في الملاحظات والخواطر والنصائح التالية: أولا- خطورة موضوعات المشروع الجينومي من حيث الآثار المترتبة على فتح أبوابه أو غلقها؛ فإنها إن فتحت على مصاريعها ترتب على فتحها مفاسد كثيرة، ورد ذكرها في أبحاث أهل الاختصاص. وغلقها بالكلية قد يترتب عليه حرمان المجتمع من مصالح كثيرة ذكرها أهل الاختصاص أيضا. وهذه الموضوعات أخطر من أي موضوع طبي جرى بحث أخلاقياته، كالتبرع بالأعضاء، ومفهوم الموت، وحقوق المعاقين نفسيا وواجباتهم، وإجراء التجارب على الجنين، ونزع أجهزة الإنعاش وغير ذلك من القضايا الطبية؛ فإن تلك الأمور لم تكن تثير مشكلات متشعبة كموضوع التدخل الجينومي تشخيصا أو علاجا أو استثمارا زراعيا أو اقتصاديا، أو تعلقا بالعقيدة والسلوك أو استدعاء لتدخل الدولة. إن هذا الوضع في المشروع الجينومي البشري قد يوجِد عند الباحث كثيرا من التأني والتردد والاختلاف، وقد حدث مثل هذا في بعض الدول المتقدمة التي سبقت في الاكتشافات المتعلقة بهذا الموضوع. ثانيا- ومما يتعلق بهذا الموضوع عدم الاستقرار في كثير من جوانبه وعدم التأكد من آثاره في حياة البشر، وبخاصة العلاج الجيني. وقد يقتضي هذا بعض الصبر والتاني لمعرفة المسار الأخلاقي المناسب. وأخطر من ذلك ما يزعم من أثر الجهاز الوراثي في سلوك الإنسان، وإمكان التحكم فيه عن طريق التدخل الجيني. ويدخل في هذا عدم وضوح آثار التدخل الجيني النفسية، والأمراض النفسية التي قد يتسبب بها، ومدى صلاحيته لعلاج هذه الأمراض. وربما كان ذلك ناتجا عن عدم معرفة العلاقة بين الدماغ والجينات، وبالتالي علاقتها مع العقل والنفس، وكل ذلك يعطي الحق لعلماء الشرع ولأهل التشريع في التأني في إصدار الأحكام بالمنع أو بالجواز. ثالثا- وقد يرجع إلى الموضوع الذي يجري البحث في أخلاقياته عدم وجود معلومات وبيانات تشير إلى كيفيات القياس والتقييم للسلبيات والإيجابيات والمآلات، ومدى الدقة في تلك الكيفيات؛ وهذا مما يجعل الحكم المفصل على قضايا ومسائل التدخلات الجينية غير ممكن والاكتفاء بالأحكام الإجمالية، وينطبق هذا على قياس مصداقية المسح الجيني والتشخيص أو التوصيف الجيني والعلاج الجيني بالنقل والأدوية. فإن بيّن لنا أهل الاختصاص شيئا في هذا المقام قبلنا منهم وبنينا عليه. ومن الأمور المهمّة التي يجب قياسها بأسلوب علمي مآلات السماح بالتدخل الجينومي أو منعه في فترات مستقبلية محدودة؛ بحيث يكون السؤال هكذا:- ماذا سيحدث لو فتحنا الباب أمام هذا النوع؟ وماذا سيحدث إذا أغلقنا الباب أمام نوع معين من التدخلات الجينية؟ رابعا- تلك أمور ترجع إلى موضوع البحث نفسه بجوانبه المختلفة. أما ما يرجع إلى علماء الاختصاص فأظن أنهم لم يزودوا إخوانهم من علماء الشريعة البيانات الكافية للحكم في كل جانب من جوانب موضوع الجينوم البشري، وربما خلطوا في بياناتهم بين الواقع والمتوقع، ولم يزودوهم بنتائج القياسات العلمية للنتائج المتحققة بالفعل، وأجملوا في بعض القضايا ولم يفصلوا، وفصلوا في بعض القضايا وبالغوا، ولم يبينوا ما أمكن قياسه من النتائج، وما يتوقع قياسه، وما لا يتصور قياسه. وخلاصة القول: إن أهل الاختصاص هم الذين يجب أن تكون منهم المبادرة، لا في تحديد المشكلة الرئيسة فحسب وهي أخلاقيات المشروع الجيني، ولكن أيضا في صياغة الأسئلة التي تعبر عن المشاكل الفرعية في كل موضوع من موضوعات ذلك المشروع. ومن الأمور التي يلاحظ فيها القصور في تصوير المسائل والبيان العلمي فيها ما يلي:- 1. من الأمور التي لا يجد الباحث الشرعي فيها وضوحا، ولا شبه وضوح، ولكن إشارات وبيانات عليها ضباب كثيف، علاقة الجينوم بالسلوك والعقائد والاتجاهات الفكرية وما شابه ذلك، علما بأن القول بارتباط الأمرين وسيطرة الجينات على العمليات النفسية يتعارض بصورة صارخة مع العقيدة الإسلامية، إلا أن يهتدى إلى تأويل مقبول؛ لأن ذلك القول يؤول إلى نتيجة عجيبة، وهي أن الإنسان آليٌّ يفعل ما تريده الجينات (المورثات). 2. لم يُرَ -فيما اطلعت عليه- ما يوضح من الناحية الطبية أن الفيروس المدجّن الذي يدخل معه الجين السليم إلى الخلية الجسدية أنه لا يذهب إلى خلية جنسية. وحقيقة السؤال: أن أهل الاختصاص هل أمكنهم تحضير فيروس موجه يوجه إلى خلايا محددة، ويبتعد عن غيرها، وهل هناك نسبة للخطأ؟ 3. كذلك لم يُرَ في تلك الأبحاث كلام حول أسباب الأمراض الجينية. خامسا- ثم إنني أعتقد أن ما تقدم في الفقرة السابقة وغيرها ينبغي أن يكون من أهل الاختصاص الدقيق، بل الاختصاص الأدق إن وجد، ولا يكتفى بالاختصاص العام من غير حظر على أحد، لكن يفترض أن تصوير المسائل العلمية لا يتقنها إلا العلماء العاملون في تلك المسائل؛ لأن من يصنع شيئا أو يكتشفه يكون أقدر الناس على تصور واقعه ومفاسده ومصالحه. سادسا ـ ومما يتعلق بعلماء الاختصاص الدقيق، و من باب الذكرى لا من باب التقييم أن اتخاذ اللازم لمعرفة الأحكام الشرعية لمنتجات العلوم وآثارها فرض كفائي يتقاسم مسؤوليته أهل الاختصاص العلمي الدقيق وعلماء الشرع، وهو من باب العمل لتحكيم شرع الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي يكتشف مواقع المعروف ومواقع المنكر ويصنعه بإتقان وإحسان يدخل في بيان المأمور به في قوله تعالى: (لتبيننه للناس ولا تكتمونه) (آل عمران: ١٨٧)، وهو من باب الشهادة التي لا يجوز كتمانها: (ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبُهُ) (البقرة: ٢٨٣). وإنما الشرط أن يكون عالما بتلك المواقع؛ لأنه شاهد، والشاهد يشهد على مثل الشمس، وللشاهد أثر عظيم في الوصول إلى الحق؛ حتى قال العلماء: الشاهد هو الذي يقضي، والحاكم يقرر قضاء الشاهد ويعطيه صفة الإلزام.
سابعا- قد يؤخذ على علماء الفقه استعجالهم في إعطاء الرأي في أمر شهد أهله أنه لم يستقر إلا في قليل من جوانبه، فإن الوضع في قضايا الجينوم البشري لم يستقر إلا في بعض مسائله؛ وهذا يقتضي عدم الفصل، وإنما الإرجاء أو التعليق على استقرار الأمر في تلك القضايا، أو توزيع الأحكام على الاحتمالات وإبقاء الباب مفتوحا أمام الاجتهاد.
ثامنا- كذلك يؤخذ عليهم أمر آخر مهم، لعل سببه الاستعجال أيضا؛ وهو ضعف التعمق في النظر وسطحية الاستدلال، وعدم فاعليته في بعض المسائل؛ومن أوضح الأمثلة على ذلك استدلال بعضهم على تحريم العلاج الجيني بقوله تعالى: (فليغيرن خلق الله) (النساء: ١١٩)، وهو استدلال غير منتج لمعظم الدعاوى، وليس فيه دلالة على تحريم كل تغيير، ولا كلِّ خلقٍ لله عز وجل؛ والمفسرون ينقلون كثيرا من الأقوال في المراد بخلق الله عز وجل، ولا يدل شيء منها على التغييرات التي يحدثها العلاج الجيني؛ فمن المفسرين من فسر خلق الله بأنه دين الله، وهو المعنى المرادف لقوله تعالى: (لا تبديل لخلق الله)(الروم: ٣٠)، ومنهم من فسره بالفطرة، وهي: تهيئة الإنسان للإيمان والاستسلام لله سبحانه وتعالى (أو تهيئة الإنسان للممارسة السليمة لإمكاناته العقلية والجسدية)، و منهم من قال: هي ما خلق الله في السماوات والأرض من أفلاك و أحجار و أشجار و ماء و غير ذلك، ليعتبر بها الناس و يشكروه على نعمه، فغيروا خلق الله بجعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل. وهناك أقوال أخرى ليس في شيء منها ما يؤيد استدلالهم المذكور. ثم إن الله تعالى خالق كل شيء، وهو خالق المغيرات والمتغيرات. وقد يرد على التغيير الإرادي الأحكام التكليفية كلها؛ فقد يكون التغيير واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مباحا. ومحصلة الكلام في هذا الموضوع لخصها ابن عطية المفسر في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز) فقال: "وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو في الآية - يعني من أمر الشيطان-، وكل تغيير نافع فهو مباح". (جـ4، ص232).
وأصل الالتباس عند بعض الناس عدم التفريق بين قضاء الله عز وجل، وما برأه الله في الواقع (يعني عدم التفريق بين القضاء والمقضي). فالقضاء لا يقدر أحد على تغييره إلا الله عز وجل، وما براه الله سبحانه في الواقع وصار أمرا مقضيا قد يكون للابتلاء (فينظر كيف تعملون) (الأعراف: ١٢٩)، وأمرنا فيه باختيار ما ينفعنا ولا يضرنا في دنيانا وأخرانا؛ كما قال تعالى: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ءاتاكم) (الحديد: ٢٢ - ٢٣). وهذه المصائب أمرنا في الوقوف منها بالتسليم، ثم بالتغيير إلى الأصلح. والتغيير الذي يحصل بالعلاج الجيني يخضع لما تقدم. ولو كان كل تغيير لخلق الله ممنوعا لما جاز العلاج مطلقا ولو كان الإنسان مريضا؛ لأن المرض كالصحة كلاهما من خلق الله عز وجل. تاسعا- ومن أمثلة السطحية في الاستدلال وضعف مستوى النظر العلمي استدلال بعض الجهات العلمية (الطبية والفقهية على السواء) على جواز العلاج الجيني بقوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) (التين: ٤)، وأن العلاج يعيد الإنسان إلى أحسن تقويم. ولو رجع هؤلاء الإخوة إلى كتب التفسير لوجدوا المعنى بعيدا عن استدلالهم، ويظهر تكلفا واضحا في ذلك الاستدلال؛ فإن معظم المفسرين قالوا في تفسير الآية بأن المقصود هو اعتداله واستواء شبابه وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها مزينا بالعقل مهذبا بالتمييز. وقال ابن العربي: "ليس لله تعالى خلق أحسن من خلق الإنسان؛ فإن الله خلقه حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما". وهناك أقوال أخرى ولم أر -فيما اطلعت عليه- أن المرض يتعارض مع التقويم الأحسن. ثم إذا كان أحسن التقويم ما ذكره ابن العربي وغيره، وكان العلاج الجيني يزيد حسنا في تلك الصفات، فلماذا لا يجوز ذلك، كما لو اكتشف من ذلك العلاج ما يزيد قوة البصر والسمع وسائر الحواس التي خلقها الله في الإنسان قابلة للزيادة والنقصان. عاشرا- وقد يحسب من باب النظر السطحي عند بعض العلماء ظاهريتهم في تطبيق قواعد المصالح والمفاسد، أنهم يعتبروا جملة ما في الشيء من مصالح ومفاسد، فما زاد منها عن الآخر كان الاعتبار له في بيان الأحكام، واستبعِد الآخر منها. وهذا لا يصح إلا في الأمور البسيطة، غير المركبة، كلعب القمار مثلا أو التدخين. وأما الأشياء المركبة التي تحتمل أوضاعا مختلفة وصورا متنوعة كما في المشروع الجينومي ومجالاته؛ فإن التطبيق السليم لتلك القواعد يكون باستخلاص المصالح واستبعاد المفاسد بالشروط والقيود والاستثناءات والإجراءات وغير ذلك من أساليب التصفية أو الغربلة، فإن أمكن ذلك أُعطي للمصالح حكم الاعتبار، وللمفاسد حكم الإلغاء. وإن لم يمكن وأمكن التقليل من المفاسد والاستزادة من المصالح بحيث تكون الثانية هي الغالبة كان الحكم طبقا للقاعدة الأصلية المذكورة أعلاه. وأما استبعاد الشيء بِرُمَّته مع إمكان تصفيته واستخراج منافعه، فهذا نظرٌ سطحيٌّ ولا يعتقد أنه منهج سليم في التعامل مع المصالح والمفاسد وجميع ما يذكر من مسائل المشروع الجينومي هو من هذا القبيل، وهي مسائل مركبة يجب إخضاعها لمنهج التحليل واستخلاص المحصلات، ولا يجوز أن تعطي حكما إجماليا. حادي عشر- ومما يؤخذ على الإخوة علماء الفقه التعميم أحيانا، بالرغم من أن أهل الاختصاص ينصحون في كثير من الأحيان أن الوضع يختلف من حالة إلى أخرى في بعض مجالات المشروع الجينومي. والحقيقة أن التعميم في الأحكام والضوابط والشروط الشرعية على مجالات التدخل الجينومي مدخل إلى الخطأ في الأحكام؛ فإنه إذا كان الفقهاء يقولون (ما من قاعدة إلا ولها استثناء حتى هذه القاعدة نفسها)، فإن المسائل والقضايا ذوات الجوانب المتعددة لا يجوز الحكم عليها بالجملة، بل ينبغي بحث كل حالة على حدة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كثيرا من الضوابط التي يعتمد عليها علماء الشرع لها استثناءات أيضا تجب ملاحظتها عند الفتوى، ولا يجوز إغفالها، فالذي ورد في توصيات وقرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمجمع الفقهي في جدة من الحكم المطلق بعدم جواز المساس بحرية الأشخاص وحقوقهم الشخصية يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق، وقاعدة تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة إذا لم يمكن الجمع بين النوعين. ثاني عشر- هناك بعض القضايا المنهجية التي كان من المستحسن مراعاتها في البحوث الطبية والشرعية، من أهمها:- 1. القضايا التي تخص الطرفين (أهل الشرع وأهل الاختصاص)، هو تحديد الهدف العام من بحوث الجينوم البشري التي يقدمها كل من الطرفين للاخر. ولا شك أن الهدف العام للإخوة علماء الجينوم من الأبحاث التي يقدمونها إلى إخوانهم علماء الشرع هو معرفة أحكام تصرفاتهم الطبية وغيرها، سواء كانت وقائية أو علاجية أو تشخيصية من الناحية الشرعية لمحاولة الالتزام بها أو الدعوة للالتزام بها. وأما الهدف العام للإخوة علماء الشرع وهو النظر في تلك التصرفات الموصوفة من أهل الاختصاص لمعرفة أحكامها الشرعية التكليفية والوضعية. 2. ثم إن تحقيق ما ذكرنا من الأهداف له طرق توصل إليه منضبطة، فإن كانت فوضوية لم توصل إلى تلك الأهداف، أو قد توصل إلى بعضها دون بعض، أو قد توصل إليها بصورة ضبابية غير واضحة ولا مؤكدة. فأما طريق علماء الجينوم للوصول إلى هدفهم فهو التصوير التام الممكن للتصرفات في جهاز الوراثة بالأسلوب السهل الواضح الذي يفهمه إخوانهم علماء الشريعة، على أن يعرض كل تصرف على حدة، وفيه بيان لحقيقته من غير توسع في حقائقه العلمية البحتة إلا ما كان له أثر في الحكم الشرعي، كالعلاقة بين الجينوم والدماغ البشري، ودوره في نفس الإنسان وسلوكه، ويعرض مع التصرف مصالحه ومفاسده وحالاته، والنسبة التي تتحقق من هذه العناصر، وكيفيات قياسها ومصداقيته ووسائله، ومحصلة الخبرات السابقة حول كل تصرف في الجينوم البشري في تلك الأمور وقواعده الضابطة كما في الإعلان العالمي للجين البشري وحقوق الإنسان، وشرح المراد من مواده أو فقراته التي تحتاج إلى بيان؛ فقد يكون في تلك الخبرات ما يوافق الشرع وينفع الناس بغض النظر عن أصحاب تلك الخبرات. ويستحسن تضمين ذلك الملف المقدم من أهل الاختصاص نتائج الواقعية بعد القيام بالتصرف، وتوقعاتهم للمآلات التي سيؤول الأمر إليها (النتائج الواقعة والمتوقعة). وأخيرا يستحسن أن يقدم الإخوة أهل الاختصاص ما يريدونه من إخوتهم علماء الشرع في صورة أسئلة تتناول تفاصيل الأمر المراد معرفة أحكامه. 3. وأما طريق علماء الشرع لتخصيص لتحقيق هدفهم من بحثهم، فهو معرفة الأحكام الشرعية للتصرفات في الجينوم البشري من خلال تنزيلها على موازين الشرع ومصادره. ولما كانت هذه التصرفات من النوازل الجديدة، وقد أدركنا أن مصادر الشريعة النقلية لا تتناولها، وأن ما ذكر من النصوص فعلاقته بهذه النوازل موهومة، وأن لا مجال لاستنباط حكمها إلا من خلال إعمال النظر في مقاصد الشريعة، وأن الأمور المسؤول عنها -مهما كانت- لا يمكن أن تكون سوى وسائل لتحقيق أنواع المقاصد الشرعية، فتأخذ حكم الوسائل؛ وبيان ذلك أن علوم المادة جميعا وسائل يقصد بها التوصل إلى مقاصد معينة، والمعارف التي توصل إليها تلك العلوم هي وسائل أيضا لمقاصد تختلف باختلاف مستعملها، وقد أصاب من قال: "ليس هناك علم حسن وعلم سيئ ، و انما استعمال المعلوم قد يكون حسنا و قد يكون سيئا". بل إن تحصيل العلوم قبل استعمالها يعتبر أمرا مطلوبا في الشرع؛ لأن الله أمرنا بالنظر في كل شيء، والعلم ثمرة النظر. والعلوم تقصد في الإسلام للاعتبار وتحصيل منافع الإنسان. فإن استعملت في المفاسد كانت ممنوعة في كتاب الله عز وجل: " و الله لا يحب الفساد" (البقرة: ٢٠٥)، وإن استعملت في كليهما كان العبرة للغالب بعد محاولة تنقيتها من المفاسد. وبناء على ذلك ينبغي أن يبدأ علماء الشرع بتحديد المقصد الشرعي الذي يمكن أن يستخدم العلم الجيني لتحقيقه أو حمايته من الأذى. ولا شك أن الله يريد الوضع الأحسن للإنسان في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل محسن ويحب المحسنين، وكتب الإحسان على كل شيء كما جاء في السنة الصحيحة، ويحب من عباده أولئك الذين يحسنون ويتقنون أعمالهم، والأحسن من الناس في ميزان الإسلام هو الأنفع لعباد الله تبارك وتعالى. فإذا تسلَّم أهل العلم الشرعي ملفات المسائل المتعلقة بمشروع الجينوم البشري لم يجب عليهم الفتوى إلا فيما استكمل من تلك الملفات بحسب ما ذكرنا آنفا. وما لم يستكمل كانت الأجوبة فيه بحسب الاحتمالات التي يذكرها أهل الاختصاص، ويكون الجواب عندئذ محتملا غير مقطوع به، ولا يؤخذ به حتى يتأكد ثبوت الاحتمال أو نَفْيُه. ويكون نظرهم بحسب ميزان المصالح والمفاسد والنفع والضرر وقواعد الموازنات بينها، وقواعد المستثنيات في بعض الصور والحالات. ثالث عشر- القضايا التي تم التوصل إلى رأي موحد بشأنها:- الإجابة على هذا السؤال تقتضي الاطلاع على جميع ما كتب في الموضوع أو معظمها. ولكني لم اطلع إلا على ستة أبحاث وتوصيات قديمة (1998م) للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وقرارات للمجمع الفقهي في جدة عام 2013م، والأبحاث بعضها لعلماء الشريعة وبعضها لعلماء الاختصاص، وفي الحقيقة تدخل أكثرهم في غير اختصاصه، وأبدى وجهة نظره، وأدلى بدلوه في الاتجاهين، وليس في هذا بأس، ولكن الأفضل أن يكون توصيف الموضوعات وتصوير المشكلات من أهل الاختصاص، ويدخل في ذلك بيان المصالح والمفاسد والمآلات. ولست أرى أن يقوم علماء الشريعة بدور التصوير والتوصيف. هذا وقبل استخراج ما توافق عليه أغلب الحاضرين في ندوة المنظمة ودورة المجمع الفقهي لا بد من الإشارة إلى أن موضوعات الجينوم البشري هي نوازل جديدة، وهي قضايا اجتهادية، وهذا النوع من القضايا الاتفاق عليها نادر، وستظل محل اختلاف بين العلماء، وبخاصة إذا ظهرت معطيات جديدة، والدولة يجب عليها الأخذ بالأصلح للأمة بحسب ما يقدره أهل الحل والعقد. وأما الأفراد فالواجب عليهم الأخذ بالأرجح حسبما يقدره لهم أهل الذكر من العلماء. ثم إن ما أمكن فرزه من المسائل المتفق عليها مما قرأته من تلك الأبحاث والقرارات والتوصيات ما يأتي:- 1. القواعد و المبادئ العامة المتعلقة بالمصالح والمفاسد دون بيان كيفية تطبيقها على المسائل التفصيلية في الموضوع. 2. حكم البحث العلمي في مسائل الجينوم واجب كفائي على الأمة الإسلامية، ويجب على أولي الأمر العمل على اللحاق بالأمم المتقدمة في هذا المجال. 3. استحباب الفحص الجيني لكل من الخاطبين قبل الزواج . 4. اعتماد البصمة الوراثية في اثبات النسب ونفيه. 5. احترام كرامة الإنسان وعدم إجباره على الفحص الجيني. 6. الاستفادة من التعرف بالجينات في النباتات والحيوانات بشرط عدم الضرر. 7. عدم جواز التدخل الجيني للوقاية من أمراض متوقعة، وجوازه لعلاج مرض واقع. 8. عدم جواز العلاج الجيني للخلايا الجسدية من أجل التحسين الشكلي أو اكتساب صفات معينة كالشكل والقوة والذكاء. 9. عدم جواز العلاج بالتدخل الجيني للخلايا الجنسية. تلك الأحكام كانت محل توصيات وقرارات المنظمة والمجمع الفقهي، ولا يمكن الزعم بأنها متفق عليها. ويمكن إعادة النقاش في طائفة منها، بل أعتقد أن ذلك يجب أن يقع في كل عام أو عامين؛ لأن موضوع الجينوم البشري متجدد في أسراره التي يبوح بها أو يكتشفها العلماء؛ فقد تكتشف مصالح أو مفاسد جديدة لها تأثير في حياة الناس والمجتمعات وتقتضي تغيير الأحكام المتعلقة بها. رابع عشر- من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث ما يأتي:- 1. تغيير السلوك الإنساني بالتدخل الجيني. 2. القواعد الفقهية ذات العلاقة بموضوع الجينوم البشري، أو تطبيق قواعد المصلحة والمفسدة والنفع والضرر، وقواعد الموازنات على مسائل الجينوم. 3. منهج البحث العلمي الشرعي في قضايا الجينوم. 4. مدى سلطة الدولة في التدخل في المشروع الجيني. 5. أحكام التصرف بالمعلومات الجانبية التي تقع للجهة الفاحصة. 6. وهذا الموضوع ربما يحتاج إلى أكثر من بحث يحسب ما يبينه أهل الاختصاص من تلك المعلومات. ومن ذلك ما ذكر في خطاب الدعوة من (اكتشاف أخطاء في الأنساب بين الناس الذين جرى عليهم الفحص). 7. قضايا الاستنساخ المشترك بين الحيوان والإنسان من أجل العلاج وغيره. 8. كيفية استنبات التقنيات الحيوية في العالم الإسلامي دون الاعتماد على الغير ( و هذا بحث لاهل الاختصاص) . أ.د. محمد نعيم ياسين

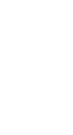
Add new comment